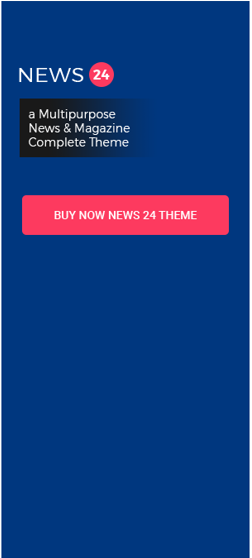تطوعت الأنظمة السياسية في العالم العربي سواء في الممالك او الجمهوريات او الإمارات بتقديم العديد من المبررات لدعم استمراريتها وتأييد سياساتها المعادية للديموقراطية والتنافس السلمي الديموقراطي، الذي يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين. من هذه المبررات ان المجتمعات العربية غير جاهزة للممارسة الديموقراطية، وان التعدد والمنافسة السياسية لم يتطورا ليكوّنا أساس الاختلاف السياسي. وعادة ما يتم تصوير التنافس السياسي على انه تعزيز للاختلاف مثل الصراع الطائفي والإثني والمناطقي. وتقدم الأنظمة العربية نفسها على انها صاحبة القواسم المشتركة التي تدفع جانباً بالتنافس غير الإيجابي. ومن جانب آخر تقدم نفسها للعالم على انها الأفضل بين البدائل المتاحة، ولكن ليس بالضرورة من وجهة نظر شعوبها.
تطوعت الأنظمة السياسية في العالم العربي سواء في الممالك او الجمهوريات او الإمارات بتقديم العديد من المبررات لدعم استمراريتها وتأييد سياساتها المعادية للديموقراطية والتنافس السلمي الديموقراطي، الذي يضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين. من هذه المبررات ان المجتمعات العربية غير جاهزة للممارسة الديموقراطية، وان التعدد والمنافسة السياسية لم يتطورا ليكوّنا أساس الاختلاف السياسي. وعادة ما يتم تصوير التنافس السياسي على انه تعزيز للاختلاف مثل الصراع الطائفي والإثني والمناطقي. وتقدم الأنظمة العربية نفسها على انها صاحبة القواسم المشتركة التي تدفع جانباً بالتنافس غير الإيجابي. ومن جانب آخر تقدم نفسها للعالم على انها الأفضل بين البدائل المتاحة، ولكن ليس بالضرورة من وجهة نظر شعوبها.
ويختلف بعض المثقفين العرب المستقلين عن مثقفي السلطة من ناحية تشخيص الظاهرة والتعامل معها. ففي الوقت الذي يرى المثقفون المستقلون ان الأسباب التي تقدمها الأنظمة ضد التنافس السياسي غير شرعية، يرى منظرو الأنظمة ان هذه الأسباب تشكل عوامل تشتيت وتفرقة للوحدة الوطنية، ويبقى الرأي العام العربي مغيباً لعدة أسباب، منها عدم وجود بيانات علمية موثوقة تدل على اتجاهات الرأي العام العربي نحو هذه الظواهر الاجتماعية ـ السياسية، وثانيها ان الرأي العام العربي غير مؤثر في عملية صنع القرار السياسي بحكم عدم وجود ديموقراطية سياسية يمكن ان يؤثر (أي الرأي العام) في مجراها.
تقدم الأنظمة العربية عروضاً لأميركا وأوروبا لخدمة مصالحها الأمنية في المنطقة، خاصة مع بروز تحديات أمنية إقليمية جديدة، منها اتضاح انهيار المشروع الأميركي في العراق، وفوز الإسلاميين في انتخابات بعض الدول العربية، وصعود إيران كقوة إقليمية. ولكن هذه العروض لم تنطو عملياً على المساهمة الجادة في وضع حد نهائي لأي نزاع. فالاستراتيجية المشتركة للنظم العربية كانت دائماً تحرص على إبقاء النزاعات الإقليمية ساخنة، بحيث تحافظ على استمرار هاجس الأمن القومي متقداً دائماً، وقابلاً للتوظيف مع الشعوب ونخبها السياسة والثقافية، لإبقاء اهتمامها مركزاً على العدو الخارجي. وبالتالي الدعم غير المباشر لمشروعية استمرارها من دون تغيير، ولكن من دون السماح لهذه النزاعات بالتفاقم الى درجة تتهدد فيها مصالح هذه النظم.
وتصور تلك الأنظمة الإسلاميين كفزاعة لتثبيط حماسة الدعوة الى الديموقراطية سواء لدى المجتمع الدولي، او لدى النخب السياسية المحلية الليبرالية واليسارية والعلمانية والقومية. كما تواصل ممارسة كل أنواع القمح البوليسي والإداري والتشريعي والإعلامي، بما في ذلك تكثيف حملات الاغتيال المعنوي عبر وسائل الإعلام للرموز السياسية الجديدة الصاعدة. كما تستغل النظم الحاكمة التناقضات والاختلافات بين النخب المعارضة، وضرب بعضها ببعضها الآخر، وخلق فجوة ثقة دائمة بينها، كي يستحيل بعد ذلك تحقيق توافقات ذات طابع استراتيجي قادرة على الصمود، مقابل القدرة الدائمة على إقامة تحالفات تكتيكية قصيرة الأمد بين النخبة الحاكمة وأقسام من النخب غير الحاكمة في مواجهة الأقسام الاخرى.
ونظراً للتشرذم الحاصل بين النخب المعارضة، لم يتوافر لها حد ادنى من قوة الدفع نحو الداخل لفرض تطبيق الديموقراطية. بل كانت مجرد أشواق تتطلع الى الديموقراطية من دون ان تكون على استعداد لدفع ثمن الحصول عليها.
يستخدم مصطلح «الانتقال الى الديموقراطية» على العكس من مصطلح «الانفتاح السياسي» للتعبير عن مرحلة أكثر تقدماً وأهمية وأشد جذرية في التغيير. فإذا كان الانفتاح السياسي يمثل إعادة ترتيب البيت القديم الذي انطفأت ألوانه وتآكلت جدرانه، فإن التحول الى الديموقراطية يعني هدم البيت القديم وإقامة منزل جديد على أنقاضه، بتصميم مختلف ومواد بناء مختلفة. ولذلك يعرف الانتقال الى الديموقراطية بأنه عملية «تفتيت النظام الاستبدادي القائم وإعادة بنائه وفقاً للأسس الديموقراطية». وتنطوي عملية الانتقال الى الديموقراطية على توسيع المشاركة السياسية بطريقة تمكن المواطنين بشكل مباشر جماعي من السيطرة الفعلية على صنع السياسة العامة.
يفتقد النظام الاستبدادي للشرعية الداخلية. وهو ما يمكن ان يحدث لأسباب كثيرة، أهمها على الإطلاق في العالم العربي التراجع الاقتصادي الفجائي. أما بالنسبة للفشل العسكري، فلا يبدو في ظل التجارب التاريخية انه ذو أهمية في بقاء النظام او زواله. إلا اذا كان الفشل العسكري في مواجهة القوى الساعية الى تغيير النظام. ويفتقد النظام الاستبدادي أيضاً للشرعية الدولية. وتعدد الأسباب التي يمكن ان تجعل النظام الاستبدادي غير شرعي في نظر المجتمع الدولي. لكن اهم تلك الأسباب هو وصول المجتمع الدولي الى قناعة بأن النظام الاستبدادي لا يلتزم بالأعراف الدولية. ويؤدي فقدان النظام للقبول الدولي الى ضمان ان المجتمع الدولي لن يعارض عملية تغييره.
يتطلب توسيع قاعدة المنادين بالديموقراطية بروز قيادة ديمـوقراطية تقدر المسؤولية وترتقي الى مستواها، وتتحلى بعنصر العمل الجماعي، والمشاركة مع الآخرين والتخلي عن عقلية الإقصاء. والاعتماد على العقل بدلاً من العاطفة في وضع برامج العمل والتصدي للتحديات.
إنَّ على القادة الديموقراطيين والقوى السياسية إدراك خطر ثقافة الاستبداد والتخلف وسط الجماهير والعمل على مواجهة أبعادها الثقافية (ثقافة الخوف، وثقافة الإفلات من القانون ومن العقاب، وتقنين الفساد بين طبقات وفئات المجتمع) وذلك باستخدام الوسائل الضرورية، من وسائل إعلام وتربية وصحافة ونشر ولقاءات مباشرة، وكذلك إنشاء مراكز لنشر ثقافة المواطنة والديموقراطية.